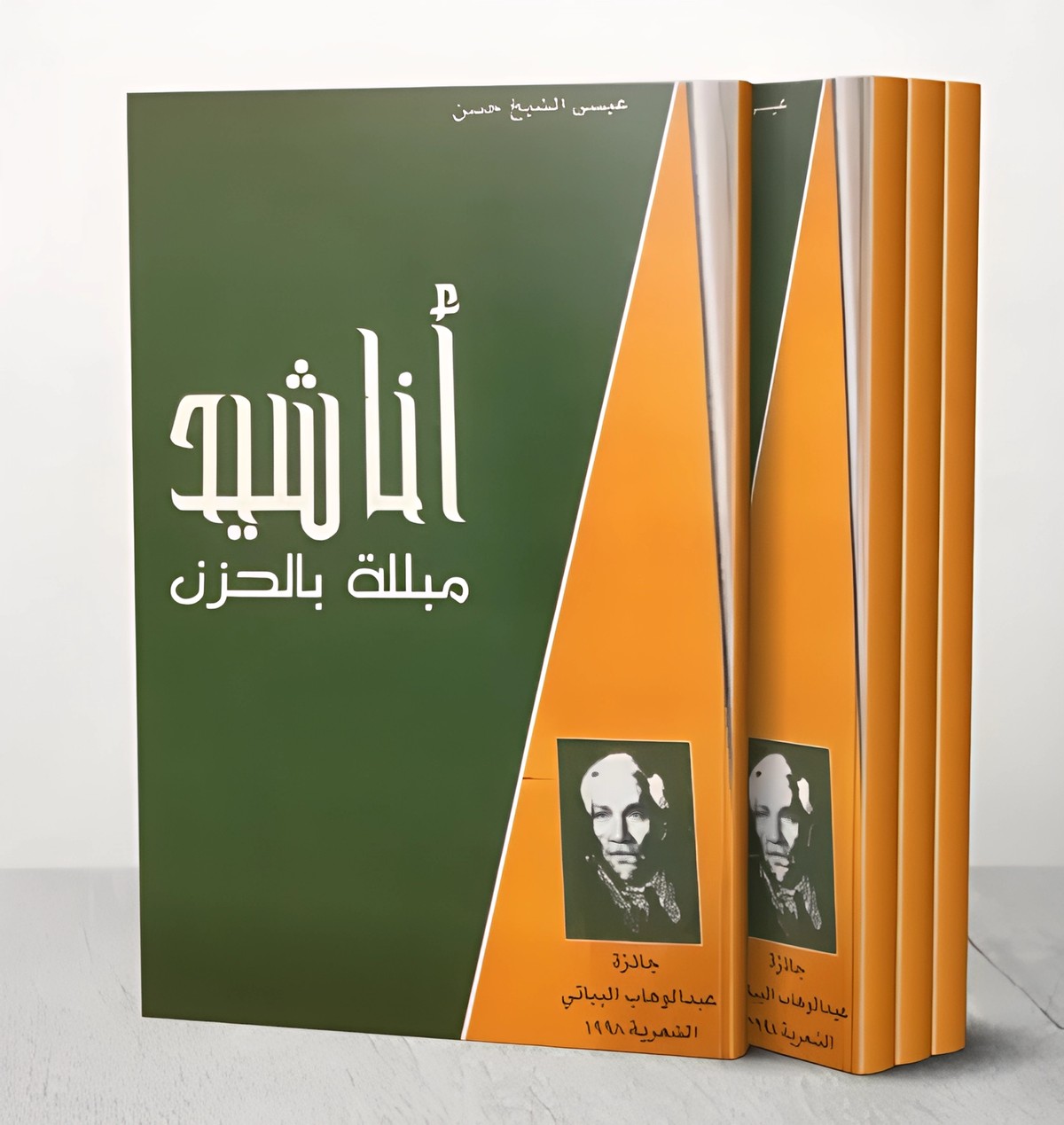عيسى الشيخ حسن شاعرُ الرفّ الأخضر يكتب سيرته بالحبر والطين

سيرةُ الشاعر والروائي عيسى الشيخ حسن لا تُروى كما تُروى السير المعتادة؛ فهي ليست خطّا زمنيا من ميلاد إلى حاضر، بل مجرى ماء يتبدّل مساره ويبقى هو ذاته: صافيا، عذبا، يحمل رائحة الطين وأصداء المواويل، ويتذكّر كل أرض مرّ بها. وُلد عيسى على ضفاف الفرات، في الرّقة التي تعني لأبنائها ما تعنيه اليمن للعرب الأوائل: أصلٌ وسرٌّ وانتماء. وكان على موعد مبكر مع الفقد، حين أغرقت مياه البحيرة قريتهم في “الحرملة”، فشدّت الأسرة الرحال شرقا نحو القامشلي.
يسمي عيسى ذلك اليوم “الخروج المائي”، لأنه خرج من بيت من طين إلى بيت من ذاكرة، ومن أرض ملموسة إلى أرض تُسكَن في القلب. ومنذ ذلك الرحيل ظلّت الرقة تنام في داخله، تستيقظ كلّما مرّ “السلهوب” بفرسانه عائدا إليها، أو حين يسمع نشيد “مندل يا كريم الغربي” يعود نشيجا على شفاه البنات وصدور الشيوخ في البلاد الجديدة.
بحثا عن وطن
في بيت العائلة كان هناك رفٌّ أخضر صغير، يحمل كنزا من أحد عشر كتابا؛ ثروة متواضعة شكّلت أول مكتبة يلمسها طفلٌ يغالب النهر ويحلم بالكلمات. على ذلك الرفّ تعلّق وعيه الأول بـ “تفسير الجلالين”، وسيرة ابن هشام، وتنوير القلوب وحياة الصحابة، ثمّ مجلدات ألف ليلة وليلة وسير الأبطال الشعبيين كحمزة البهلوان، والزير سالم، وبني هلال. ومن فوق هذا الرفّ بدأت مملكته السردية تتكوّن، كأنّ الحكاية خُلقت لتكون وطنه البديل عن “الحرملة” الغارقة.
حين انتقل إلى المدينة، فتحت له مكتبة المدرسة أبوابا جديدة، فعرف عبرها نجيب محفوظ، والطيّب صالح، وعبدالسلام العجيلي، ومراد السباعي، وفارس زرزور، ثم عبر الجسور إلى همنغواي وغوركي. هناك، بين الواقعي والعجائبي، مالت روحه من السرد إلى الشعر، من الحكاية إلى النشيد، حتى “سال القلم” على حدّ عبارته، فسبق الشاعرُ الساردَ، وباتت اللغةُ عنده نهرا آخر يواصل جريانَه، يحمل معه بقايا الطين الأول وصوت الأمكنة الغائبة. وهكذا ظلّ عيسى الشيخ حسن يكتب ليعثر في الكتابة على الوطن الذي خسره، وفي الحكاية على بيت يطفو فوق الماء، لا يغرق أبدا.
قضايا الثأر والعرف

حين يروي أستاذُه حسين العسّاف ذلك الزمن، يقول إنّ تلميذه في معهد إعداد المعلّمين أتقن شكل القصيدة وهو في العشرين، وإنّ البشارة سبقت النشر. تأخّر عيسى عن المنابر، وكاد يزهد فيها، لولا أن جائزة عبدالوهاب البيّاتي (1998) طرقَت بابه كمن يوقظ فلاحا شابّا فجرَ الحصاد “اسق أناشيدك”. فكان الديوان الأوّل “أناشيد مبلّلة بالحزن”، ثم أتبعته دائرة الإبداع في الشارقة بـ“يا جبال أوّبي معه” (2001). هناك، كان الاغتراب قد بدأ يشحذ الموهبة بوجع لذيذ، وكان المعلّمُ الذي سيقضي خمسة وعشرين عاما في الدوحة يكتشف أن الصفّ الدراسيّ فضاءٌ للإنسان قبل أن يكون مقرّا للحفظ والاستظهار.
التدريسُ لم يمنحه “أريحية المهرجانات”، لكنه أعطاه ما هو أدوم: إتقان الصنعة، صبرا على اللغة، وقدرة على الإصغاء إلى الناس وهم يتهجّون حياتهم. ولأنه ظلّ على صلة بالحبر الساخن، كتب زوايا في “الوطن” و“الشرق” القطريّتين، ونشر نصوصا ومقالات في أوعية سورية وقطرية وعربية. لقد أبقته الصحافة على تماس مع نبض الأدب، وأعطته نَفَسَ الراوي الذي يلتقط الخبر فيجلو عنه رطانة العابرين.
غير أن صورة عيسى لا تكتمل بلا الريف الذي كتب عنه ومنه. روايته “خربة الشيخ أحمد” ليست مجرد حكاية عن قرية مهملة على خرائط المدن؛ إنها مرآةٌ تمسك بيد القارئ وتدخله إلى بيت الطين: إلى لهجة الشاوية، إلى كرم بيوت تفرش ما لديها على موائد الشاي، وإلى أعراف تشدّ أهلها كما يشدّ الحبلُ سقفَ العريش.
هنا نجد الحاجّ عبداللطيف وقد جاوز التسعين، وياسين الذي ربّاه في كنفه، وفواز وزوجته وابنتهم حسنة، وجاسم الذي يظنّ أن “المحيّرة” قدرٌ لا يُبدَّل، وأن ابنة العمّ كالأخت تُحجَب أحلامها عن الخارج. ثمّ حادثة الرصاصة الطائشة في قاعة المحكمة، تلتبس فيها العدالة بالمصادفة والقدر بالخطأ، فتتبدّل مصائر الشخصيات جميعا.
بهذه البساطة المتعمدة، وبهذا العمق الذي لا يتعالى على الكلام اليومي، يعالج الكاتبُ قضايا الثأر والعُرف، فلا يشتم الماضي ولا يبرّئه؛ يضعه أمام مرآة اليوم، ويسأل: هل من حقّ القلب أن يكسر السياج إذا كان السياجُ يُهين كرامته؟
في نصوصه، يتعامل عيسى مع التفاصيل كبطولة صامتة: صحنٌ في آخر المائدة “يُكمل العدّ” بدل المفقودين، صورةٌ “بإمكانها أن تصبّ العشاء”، أمٌّ تغصّ بأسماء أبنائها السبعة. وهو إذ يكتب الحروب، يكتبها على الجدار: ثماني رصاصات نبتت ثقوبُها في شقّة مقابلة، صار كلّ ثقب عشبة خضراء.
يروي لنا عن أمّ تشير إلى ثقبَين متجاورين فتتذكّر التوأمين، ثم تقول عبارتها الطويلة “إيييييييييييه ع الدنيا” وتصمت. الأدبُ هنا لا ينوح؛ بل يسقي العشب الذي أنجبه الموت.
◄ عيسى الشيخ حسن ظلّ يكتب ليعثر في الكتابة على الوطن الذي خسره، وفي الحكاية على بيت يطفو فوق الماء
لهذا لا غرو أن يعود الشاي في كتاباته طقسا للذاكرة: ليس مشروبا، بل جسرٌ بين بشر. في القامشلي، في مقهى بواجهة زجاجيّة مفيّمة، يُفرغ حصّة السكر في كأس صديق ويقول له: “برّد قلبي واشرب بسكّر مضاعف”. وعلى ضفاف الفرات يشربُ الشاي مع أصدقاء تتكرّر أسماؤهم كالأهازيج: إبراهيم الزيدي، إبراهيم المرعي، أحمد محيمد، وأستاذه أحمد حسين عيسى. الشاي، في هذه السيرة، ليس تفصيلا؛ إنه المعادل الموضوعيّ لفكرة الودّ: أن يُعزّى القلبُ بحلاوته، وأن تُستعاد البلاد في بخاره.
ولأن السرد ظلّ واقفا خلف الشاعر، عاد خطوة إلى الأمام في “العطشانة”؛ رواية كتبها قبل “خربة الشيخ أحمد” لكنها صدرت لاحقا في فبراير 2024 عن دار جدار للثقافة والنشر (الإسكندرية/ مالمو)، في 118 صفحة، 27 فصلا، ومتاحة إلكترونيّا مجّانا.
يصفها الكاتب بأنها محاولة لتوثيق بيئة ريفية تواجه مصائرها بالموت والرحيل، لا استسلاما ولا صخبا؛ بتسليم ومحبة. هناك أيضا مشروعٌ آخر ظلّ مفتوحا: تأصيل الشفويات الريفيّة الفراتيّة؛ وهو عملٌ يتطلّب من الصبر بقدر ما تتطلّبه الريحُ من حارس يقفُ على تخومها… ليس عبثا إذن أن يلقّبه أصدقاؤه بـ“سادن الريح والمواويل”.
وللأصدقاء هنا نصيبٌ وافر من السيرة: فقد صدر عن دار قرطاج كتابٌ جماعيّ “سادن الريح والمواويل: شهادات ونصوص في تجربة الشاعر عيسى الشيخ حسن معلّما وصديقا وشاعرا وروائيّا”، فكرةُ إنجازه من عماد أحمد، وفيه اثنان وخمسون صوتا يكتبون عيسى كما عرفوه.
يقول هو إنّه بكى وهو يقلّب صفحاته: لا لأنه مجَّد نفسَه، بل لأن الوجوه التي حضرت تشبه عدد الشَّوايا الأثير، عدد يتفاءل به ويأنس. يكتب صديقه محمد الجبوري جملة تُشبه أسلوب عيسى نفسه: “كل أشجار العالم تبكي عندما يقول: هلي”. تلك الجملة، وحدها، تكفي لتفهم كيف يمشي عيسى بين الناس: ببطء شاعر، وخفّة ريفيّ يعرف الطريق إلى الماء.
نبرة الحزن المهذب
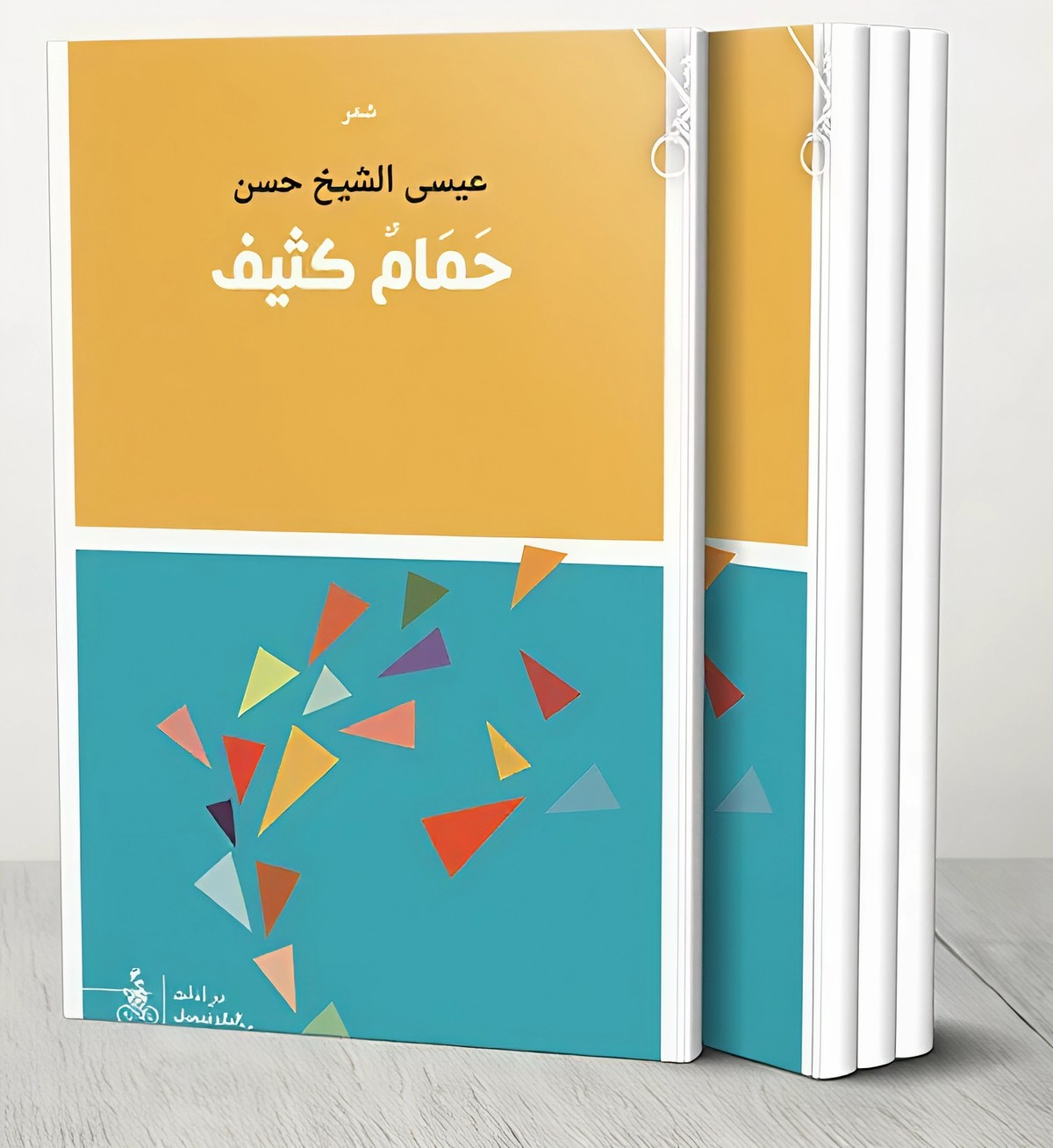
لكن ما لا يقوله الأصدقاء بصراحة، يقوله النصّ من طرف خفيّ: الحزنُ سمةٌ مُهذّبة في هذه الشخصية؛ فقد غيّب الموت أمّا وزوجة، وفرّقت المنافي الأهلَ ربع قرن. ومع ذلك ليس حزنا قاتما؛ بل نبرةٌ خفيضة تمسح على كتف القارئ ثم تمضي. تعلّم عيسى في جامعة حلب أن العربية بيتٌ حين تضيق البيوت، فحافظ على وفائه لها معلّما وكاتبا، وظلّ يؤثثُ هذا البيت بمفردات من لهجته: “حيّار، محيّرة، شير”؛ لا للزينة، بل لأن معنى الأشياء يخرج من أفواه الأمهات أكثر مما يخرج من القواميس.
على هامش السيرة، أو في متنها، ثمّة عشقٌ قديم لكرة القدم. يدخلها عيسى من باب الثقافة: يروي أنه في صيف 1978 حمل راديو صغيرا إلى المرعى، يسمع عدنان بوظو في الخامسة إلا ربعا يتحدّث عن كأس العالم وأسماء تونسية صارت أبطالا في خيال الصبي: الشتالي، النايلي، العقربي، تميم، طارق ذياب، نجيب الإمام. ثم 1982: تلفزيونات تمتلئ بها القرية، وبيروت تسقط فيما العالم مأخوذٌ بفريق الأحلام البرازيليّ، قبل أن يذبح باولو روسي الجمال في مواجهة النتائج. ثم 1986: مارادونا يمشي بالكرة من منتصف الملعب كمن يعيد إلى وطنه الجزرَ المفقودة.
◄ بين الواقعي والعجائبي مالت روحه من السرد إلى الشعر من الحكاية إلى النشيد حتى “سال القلم” على حدّ عبارته
لا يكتب عيسى الكرة كحدث رياضيّ مجرّد؛ يكتبها بوصفها بديلا مُتحضّرا للحرب. يُذكّرك أن مباراة فرنسا وإنكلترا يمكن قراءتها كحرب المئة عام مختزلة في مئة دقيقة، وأن مباراة أميركا وإيران تواصلٌ ثقيلٌ بقدمين. وفي مونديال الدوحة يحيّي درس التنظيم والضيافة، ويشير إلى أن العرب أعادوا تقديم وجههم بعيدا عن القوالب الجاهزة: “نُحسن تنظيم البطولات، ونحسن اللعب، ونحسن التشجيع”.
ومثل كلّ سيرة صادقة، لا تخلو هذه من الأوسمة التي عزّزت الطريق ولم تصنعه وحدها: جائزة الشارقة للإبداع الأدبي (الدورة الخامسة) إلى جانب جائزة البيّاتي الأولى، وإصداراتٌ شعريّة وسرديّة: “أناشيد مبلّلة بالحزن”، “يا جبال أوّبي معه”، “أمويّون في حلم عبّاسي”، “مرّوا عليّ”، “حمّام كثيف”، “سرديات رمضان: آيات ووجوه وأمكنة”، “خربة الشيخ أحمد”، و“العطشانة”.
غير أن الكاتب الصحفي الذي يدوّن هذه السطور يتوقّف طويلا عند ما بين الكتب من هوامش: عند ربابة صُنعت من شعرة حصان وجلد غزالة وغصن شجرة؛ عند ثمانية ثقوب على جدار صار كلّ واحد منها عشبة خضراء؛ عند كأس شاي تُقاس به حرارة الحنين؛ عند أمّ طويلة الأناة تمسح بيد من دمع على أسماء أولادها؛ عند معلّم يتأبّط اللغة ككتاب حضور لا كشهادة موظّف.
أمّا المعمار الذي تتكئ عليه النصوص، فهو عمارة الريف: سقفٌ من عود وقصب يثقّب الضوء على حصير قديم، ساحةُ دار يتقاسمها البشرُ والمواشي، جدارٌ طينيٌّ يُسند ظهوره العجائزُ في ظهيرة بعيدة. ليست هذه الديكور؛ إنها شخصيةٌ إضافيةٌ في الرواية: حجارةٌ تعرف أسماء أصحابها، وزربٌ يحفظ ذاكرة الخطى، وعريشٌ يُعيد توزيع الظلّ بعد كلّ غروب.
صوت الأمكنة الغائبة

يليق بنا أن نعيد تعريف الرجل كما يليق بالصحافة حين تقترب من تخوم الأدب وتلامس جوهر الإنسان. عيسى الشيخ حسن، معلّمٌ أصابته القصيدة فأنطقتْهُ شعرا، وشاعرٌ لحقه السردُ فصار روائيا، وروائيٌّ لم ينسَ أن يكون إنسانا يُطعم نصَّه من تفاصيل الحياة لا من استعراض البلاغة. في كتابته، لا يتعالى على الواقع ولا يستسلم له، بل يحيله إلى معنى، ويصهره في لغة تتّسع لليومي والعابر، وللمقدّس والعادي في آن واحد.
هو ابنُ الرّقة والقامشلي وأمّ الفرسان، ابنُ سهوب تعرف معنى الانتظار، ومقيمٌ طويلٌ في الدوحة التي حمل إليها صدى طفولته ولهجة الريح. في جيبه مفردات الأم وذاكرة الحكاية، وفي قلبه أصدقاء يكتب عنهم كما يكتبون عنه، كأن الودّ نفسه تحوّل إلى لغة.
وإن سألته عمّا يبقيه، أجابك بما يشبه الاعتراف الشعري الذي سبق أن سمعناه في نصوصه قبل صوته: “يبقيني أن أؤمن بأن صورة على الحائط يمكن أن تصبّ العشاء، وأن قصيدة قد تكون سقفَ ليل لغريب، وأن رواية من قرية صغيرة اسمها الصفرة قادرةٌ على فتح نافذة على العالم”. ذلك الإيمان البسيط، العميق، هو ما يصنع كاتبا حقيقيا: أن يرى في التفاصيل الصغيرة حياة كاملة، وفي اللغة بيتا للعابرين.
هكذا تُكتب السيرة حين يكتبها كاتبٌ عن كاتب؛ ليست تتابعَ وقائع، بل نبضا يُصاغ في الكلام، محاولة للقبض على ما لا يُرى من حياة تنبض تحت الحروف. فالسيرة هنا ليست حكاية إنجاز أو توثيق مسار، بل مرآةٌ لإنسان ظلّ يرى في الأدب خلاصا شخصيا وجماعيا في آن، ويؤمن أن الكتابة نوعٌ من الإيمان الخفيّ، يُرمّم ما انكسر في الروح.
وحين نطوي الصفحة، لا نغادر المكان حقّا، بل يبقى الصوت فينا. نكاد نسمع ربابة بعيدة تستدعي الذاكرة من منفاها، ونكاد نرى الراوي وهو يقول في أعماقه: هَلي. عندها تبكي الأشجار، بعضها في الرّقة، وبعضها في القامشلي، وبعضها الآخر، هنا، في قلب القارئ الذي يدرك أن الأدب حين يُكتب بالصدق، يُعيد للأمكنة الغائبة صوتها الذي لا يغيب.