عزيز العرباوي لـ"العرب": ماضينا ما زال عقبة في طريق التقدم والتطور والتجديد

في ظل هذا الكم الكبير من الإصدارات الأدبية في العالم العربي، فإن اللوم موجه دائما للنقاد لقلة جودة الكثير من هذه الإصدارات، بينما يتجاهل اللائمون أن النقاد ليسوا مسؤولين بمفردهم عن واقع أدبي متشابك. "العرب" كان لها هذا الحوار مع الناقد المغربي عزيز العرباوي حول رؤيته لواقع النقد العربي وأدواره.
يرى الناقد المغربي عزيز العرباوي أن النقد العربي يعيش أزمة يصعب علينا تحديد ملامحها وحيثياتها الأساسية؛ نظرا إلى غموض الوضعية واستسهال الكتابة النقدية عند الكثيرين الذين جعلوا من النقد وسيلة لتحقيق غايات وأهداف شخصية مادية ومعنوية.
كل هذا يخلق للنقد العربي مشكلات كبيرة تتعلق بقدرته على قراءة ما ينتج ويصدر من نصوص إبداعية بشكل هستيري لا يراعي أية خصوصية أو إمكانية متاحة.
الكتابة والذاكرة

يتحدث العرباوي لـ”العرب” عن كتابه النقدي “الذاكرة وآليات اشتغالها في الرواية العربية” قائلا “إنه ثمرة مجهود سنوات من القراءة والبحث والتفكير في المتون الروائية التي اشتغلت عليها، ثم إنه من الصعب اقتحام موضوع الذاكرة، ذاكرتنا العربية والإسلامية، لكونها ذاكرة عاشت العديد من الصراعات على مستوى التفكير والحفظ والتدوين والإفصاح عما يعتريها من عورات ومساوئ ومشاكل وصراعات كبرى على المستوى السياسي والديني والثقافي والاجتماعي.”
ويؤكد أن أغلب من كتب عن الذاكرة أدبيا، أو حاول أن يعيد إحياءها من جديد فنيا أو ثقافيا أو حتى سياسيا، تعرض لنوع من الانتقاد، علاوة على الصعوبات التي اعترضته في أبحاثه وتنقيباته وأشكال تحقيقه في التاريخ والتراث العربي.
ويضيف “في هذا الإطار يمكننا القول إن الذاكرة عامة تعمل على إعادة إحياء العديد من الموضوعات والتيمات في أبعادها المعنوية والدلالية من خلال وقوفها على مشاعر الألم والتأزم والخيبة الذاتية، إضافة إلى مقاربة الكثير من القضايا المرتبطة بالشعور الفردي وعلاقة الفرد بالجماعة، مثل: الحب، الهجرة، الجنس، الموت، الزواج، السياسة، الخيانة، الحلم، الطموح، الجسد، اليتم، العمل، الرفاهية، الفقر، التطرف، الحقد، الألم، السلم، الحرب.”
ويواصل العرباوي “كل هذه الموضوعات تتحكم بالسارد وبذات المحكي، وترتبط بتفاصيل حياته وتوجه رأيه ومسار تفكيره. إن الرواية العربية عموما، وهي تنفتح طوعا على الذاكرة، تشكل بذلك وظيفتها المعرفية وهي تعيد إنتاج الماضي، سواء من خلال ما تحدده المقصدية الإخبارية للسارد في النص الروائي أو المقصدية التواصلية التي تتأسس على إنتاج معنى ضمني غير معلن. إن الذاكرة في إطار اشتغالها لبناء المعنى داخل النص الروائي، يحفزها المؤلف من خلال سارده على المضي في بناء منجز سردي مأهول بنضج التخييل الذاتي والغيري، وتجميع شتات المعرفة المنثور في جانب مهمل من الذاكرة، والمغلف بمستويات متعددة من سراب الواقع والمجتمع والتاريخ والذات الإنسانية المغرقة في الوهم.”
ووفق مؤلفه يمثل الكتاب محاولة لدراسة الذاكرة ومدى اشتغالها في الرواية العربية من خلال مقاربته لنصوص روائية متميزة استطاعت أن تستند إلى الذاكرة كمنهجية ومنهج للسرد الروائي، وتقديم المعرفة للقارئ المتلهف إلى ما يعيده إلى ماضيه البعيد والقريب معا.
أما عن الصعوبات التي واجهته في إعداد هذا الكتاب فيقول العرباوي “لا يستطيع أي ناقد أو باحث أن ينكر مدى صعوبة المغامرة في البحث في مجال محفوف بالمخاطر وصعب التناول كموضوع الذاكرة، سواء في ارتباطه الوثيق بالتاريخ كمادة علمية تنقل الأحداث والوقائع التاريخية الكبرى، أو في ارتباطه بمادة السرد والحكي التي تثير العديد من الأشكال الخلافية حول مدى وصفها بالتخييل من عدمه. فمسألة التخييل وعلاقته بالتاريخ مسألة فيها الكثير من الإشكالات التنظيرية الخلافية التي ما زال العديد من النقاد والباحثين يجدون فيها أمرا لا فصال فيه نهائيا ما دامت الرواية اليوم تقتحم عنوة وبقوة كبيرة مجال التاريخ وتحاول أن تسيطر على بعض أساليبه الكتابية وأشكال التعاطي معه من قِبَل المؤرخين أنفسهم.”
النقد هو السبيل الوحيد لإعادة النظر في مدونتنا الأدبية وعدم وضعها في موقف محرج أمام القارئَيْن العربي والعالمي
ويضيف “من هنا، يمكنني القول إن صعوبة البحث في الذاكرة تقوم أساسا على مبدأ الفصل بين التاريخ والرواية، حيث يعدّ التاريخ تدويرا أو بالأحرى نزيفا للواقع الذي يعلو على التخييل الروائي، فالكاتب الذي يسرد التاريخ متخيلا يكتب وهو في غفلة عن سارديه النمطيين، بل بعيدا عن ذاكرتهم أو عما يحاولون أن يتخيلوه سرديا لأنه يحاول أن يسيطر على ما يكتبه من خلالهم. التاريخ إذن سارد من نوع آخر، يتناص مع تفاصيل الزمان والمكان، ويحاول محو ما يقدمانه من عناصر واقعية محضة تقسو على شخصيات الرواية ويجعل من السنوات القاحلة والأعمار المعذبة شيئا مختلفا يقدم معرفة للقارئ بشكل ملؤه الحفاوة والفرح بما يقرأه مهما كانت منطلقاته المعرفية والفكرية والأيديولوجية. غير هذا الذي ذكرته، فلا توجد صعوبات أخرى.”
تسأل “العرب” العرباوي عن اتجاهه الفكري والنظريات النقدية التي يعتمدها في تناوله للأعمال الإبداعية، ليجيبنا “عندما نتحدث عن الاتجاه الفكري فإنه لا بد أن نعرج على أهم الأفكار والمعارف التي تلقيناها من قبل، إضافة إلى ما عشناه من تجارب في الحياة والعلاقات الإنسانية؛ وهذا ما يؤكد على أن أي اتجاه فكري ينبغي أن يكون نتيجة هذه الأمور، حيث المعرفة هي الهدف واكتساب التجربة الحياتية والعلمية يأتي بالدرجة الأولى. ولا يمكننا أن نجد هذا خارج إطار المعرفة الإنسانية التي نقرأها ونبحث عنها في كتب الأولين والآخرين، وكتب الباحثين والنقاد الغربيين والعرب الذين أغنوا الخزانة المعرفية بأمهات الكتب والمصادر.”
أما في ما يتعلق بالنظريات المعتمدة في قراءته وتحليله للأعمال الأدبية فهي النظريات الأساس التي لا يستقيم النقد والتحليل الأدبي من دونها، وهي كثيرة يذكر منها: نظرية التلقي، النظرية التداولية، النظرية الأسلوبية، النظرية الهيرمينوطيقية.. وغيرها، إضافة إلى استدعائه بعض المناهج النقدية وأهمها المنهج السيميائي والمنهج البنيوي، وقد يعتمد في بعض الأحيان على المنهج التكاملي.
النقد وأهميته
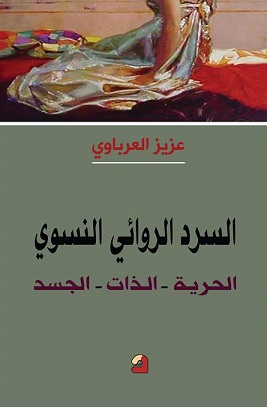
حول علاقة الناقد بقضية أو مقولة “موت المؤلف” وأيضا “موت الراوي” يقول الناقد المغربي “تعود قضية ‘موت المؤلف’ إلى الناقد والباحث الشهير رولان بارت الذي حاول من خلالها أن يجعل من النص الأدبي محور عملية النقد وأساسها، حيث إنه من الضرورة بمكان أن تصير للنص تلك الاستقلالية عن مؤلفه، حتى وصل به الأمر إلى الدعوة إلى قتله مجازا لا حقيقة.”
ويرى أن مسألة موت المؤلف هي الأساس في قراءة النص ونسيان اسمه من الوسائل التي تتيح للقارئ استبعاد ذاتية المؤلف وشغفه وميوله، حيث إنه مجرد سيناريو لا أكثر، ومن هنا تكون قراءة النص قراءة نقدية ليست بالضرورة أن تكون مرتبطة به ومتعلقة بما يريده. وبالتالي يكون للغة النص دور كبير وأساسي في تحديد مدلول النص وعلاقات جمله واحدة بالأخرى، باعتباره الأساس ليأتي بعد ذلك الدور على القارئ لكشف المعنى وتحديد الدلالة.
ويضيف “غير بعيد عن مسألة موت المؤلف يمكننا أن نتحدث عن قضية أخرى هي مسألة ‘موت الراوي’ التي كان الهدف منها التهجم على السرديات الكلاسيكية والدفاع عن تصور مختلف عن هذه السرديات، من خلال الدعوة إلى ما يسمى بالسرديات ما بعد الكلاسيكية؛ حيث نجد أن نظرية موت الراوي لا تختلف عن موت المؤلف، باعتبارها مجرد تجديد لموت مؤلف الإبداع السردي في حد ذاته، من خلال توليد جهاز نظري متكامل وجديد.
ويلفت إلى أن من أهم من تبنى هذا المفهوم سيلفي باترون التي دافعت عنه باستماتة في كتاباتها المتعددة، انطلاقا من كتابها “الراوي: مدخل إلى النظرية السردية” عام 2009، مرورا بالطبعة الثانية المنقحة من الكتاب نفسه بعنوان جديد “الراوي: قضية النظرية السردية” عام 2015، ثم أخيرا وليس آخرا كتابها “موت الراوي ومقالات أخرى” عام 2016.
تسأل “العرب” العرباوي عن أسباب توجه النقاد إلى كتابة الرواية، وطغيان الرواية على الأجناس الأدبية الأخرى، فيقول “ليست هناك وصفة واحدة للكتابة السردية والإبداع عموما، وبالتالي لا يمكننا أن نحصر الكتابة الإبداعية في أصحابها دون غيرهم من النقاد والباحثين والعلماء. فهناك نقاد متميزون استطاعوا أن يكتبوا نصوصا روائية وشعرية عظيمة تركت أثرها الكبير في نفوس القراء والنقاد، سواء في الغرب أو في العالم العربي. وتحضرني الآن أسماء من قبيل الناقد والروائي المبدع محمد برادة، والشاعر الناقد محمد بنيس، والناقد المبدع شكري المبخوت وغيرهم كثيرون. فأغلب هؤلاء النقاد كتبوا في مجال الرواية على الخصوص، لأنها أصبحت الحصان الرابح في سباق الكتابة الإبداعية اليوم في عالمنا العربي؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرواية، في إطار بروزها وطغيانها على باقي الأجناس الأدبية الأخرى، وجدت لها فضاء للحرية والتعبير أكثر من غيرها.”
ويتابع “إن سؤال السرد العربي يستدعي العديد من الجوانب الأساسية لتحليله والوقوف على ملامحه واتجاهاته المعرفية والثقافية؛ حيث إنه سرد يبالغ في التكرار، تكرار الموضوعات والقضايا المطروحة، ونكاد نجد أن النسبة الكبيرة من النصوص الروائية التي تمّ نشرها في العقود الأخيرة قد تطرقت إلى أحداث التاريخ العربي والإسلامي، والنسبة المتبقية خصصت للمواضيع العاطفية والاجتماعية على قلتها. وهذا الأمر دليل على أن الماضي ما زال بالنسبة إلينا عقبة في طريق التقدم والتطور والتجديد، تجديد الذات والفكر والعقل.”
ورغم إقرار العرباوي بأن النقد العربي يعيش أزمة، فإنه في رأيه السبيل الوحيد لإعادة النظر في مدونتنا الأدبية وعدم وضعها في موقف محرج أمام القارئَيْن العربي والعالمي. لقد وصل استسهال الكتابة الإبداعية اليوم بفضل منصات التواصل الاجتماعي وتفريخ المواقع الإلكترونية إلى مدى أصبح فيه الأدب العربي بمثابة مقهى عمومي يدخله أي أحد متى شاء؛ والسبب بالطبع ليس النقد، لأنه قاصر على الإحاطة بكل ما ينشر أو قراءة هذا العرمرم من المنشورات هنا وهناك، بل هي مسؤولية دور النشر التي أصبح الربح يعمي عينيها عن أهم شيء وهو المساهمة في نشر الأدب الأصيل والجميل والهادف.

في عصر السرعة والعولمة والشركات العابرة للحدود والصراعات الحضارية، تسأل “العرب” العرباوي كيف للنقد أن يساهم في خلق أدب جاد وأصيل؟ فيجيبنا “السرعة والعولمة والصراع الحضاري.. وغيرها من الأشكال المعبرة عن التخوف من الآخر المختلف عنا، هي حقّ أريد به باطل. كيف ذلك؟ أعتقد شخصيا أن هذه الأشكال الحضارية والتواصلية التي أبدعها الغرب هي شكل رائع للتطور الإنساني عامة دون تمييز أو تحديد، فصاحب هذه الاكتشافات العلمية وهذه الطرق المتطورة للتواصل لم يكن لينشئها أو يبدعها لو علِم أنها ستكون وبالا على الإنسان كيفما كان في العالم، نظرا إلى أن أول من استغلها وعمل بها هو من اكتشفها وأبدعها. وإلا فهو يبحث عن خرابه وخراب مجتمعه قبل خراب مجتمعاتنا. ثم كيف لنا ألا نستفيد من كل هذا التطور في تطوير نظرتنا للأمور والعالم، والبحث عما يجمعنا مع الإنسان أينما وجد؟”
ويواصل “هنا يأتي دور النقد العربي الذي هو مطالب بتجديد نظرته لما ينشر من أدب عربي وينتقي منه الجيد والمتميز والواعي وتقديمه إلى القارئَيْن العربي والعالمي، وجعله النموذج الحقيقي لأدبنا، سواء من خلال إعادة قراءة تراثنا الأدبي الجميل والجيد، أو من خلال متابعة ما ينشر هنا أو هناك ووضع أسس ومبادئ محددة وشروط للكتابة الأدبية الحقيقية والجيدة دون مصادرة الحق في الكتابة للجميع. فقط هو مطالب بجعل أدبنا رياديا على أساس احترام حقيقي لشروط الكتابة الأدبية التي تحقق الجودة والتميز.”
تسأل “العرب” العرباوي لماذا -حتى الآن- لم ننتج نظرية عربية تستوعب كل الفنون والآداب، رغم الإرهاصات الأولية؟ ليقول “هذا السؤال مؤرق حقيقة لكل ناقد عربي، مؤرق لأنه يدرك مدى صعوبة إنتاج نظرية عربية حقيقية نؤسس عليها نقدنا وإبداعنا وفكرنا؛ فنحن لا ننتج المعرفة أساسا، بحكم أننا مجرد مستهلكين لما ينتجه الآخر، أو أننا ما زلنا نعيد إنتاج تراثنا الثقافي، سواء بتقديسه وعدم التصرف فيه أو بجعله نصوصا صادقة لا يداخلها الكذب أو التخييل أو التزوير أو حتى التشويه.”
ويتساءل “كيف في ظل هذه النظرة التقديسية والقاصرة أن ننتج من خلالها نظرية عربية؟ وكيف لنا أن ننتج نظرية نقدية واحدة على الأقل في ظل اختلافنا حول الأسس والمرجعيات التي تحكمنا؟ بل كيف لنا أن نفكر في إنتاج معرفة عربية ونحن ما زلنا نتصارع على أحقية هذا أو ذاك في القيادة والتملك والرئاسة؟”
ويختم “إننا ما زلنا في حاجة إلى النظرية الغربية لمقاربة نصوصنا الإبداعية والفنية، لأننا غير قادرين على إنتاج نظرية عربية قادرة على استيعاب أدبنا العربي رغم وجود منطلقات تراثية قديمة وحديثة استطاعت أن تضع المبادئ الأولية لإنتاج النظرية المعرفية والنقدية العربية وفق شروط ثقافية واجتماعية وفلسفية موحدة؛ فنحن إما خائفون من المغامرة، مغامرة إنتاج المعرفة، وإما فاشلون حقيقة في الأمر ونحتاج إلى من يخرجنا من خوفنا ويبعده عنا حتى نغامر وندخل غمار إبداع النظرية النقدية وإنتاج المعرفة العربية التي تليق بنا كأمة وحضارة وثقافة أصيلة.”






















