عبدالسلام الفقهي لـ"العرب": العنصر الحاسم في أي حوار هو الصبر

تسهم الحوارات في كشف الكثير من خفايا المبدعين، وتمثل نوافذ مهمة لفهم أفكارهم وعوالمهم، ولا يتوفر ذلك إلا مع محاور يدرك جيدا التنقل بين الأسئلة ويعي خصوصية تجربة كل من يحاوره. "العرب" كان لها هذا الحوار مع الكاتب الليبي عبدالسلام الفقهي الذي يدرك أهمية الحوارات وخصوصيتها وقد خصص لها كتابه "جسور".
"جسور" كتاب لعبدالسلام الفقهي يبحر في تجارب نخبة من رموز المشهد الأدبي الليبي، ضمن حوارات ولقاءات تقتفي إسهاماتهم في مجال الشعر والقصة والرواية والنقد والترجمة والتوثيق، مستنطقا وجهات نظرهم.
أسئلة كثيرة طرحها الكتاب، الصادر مؤخرا عن دار السراج للنشر والتوزيع، كونت جسرا بين الكاتب وضيوفه، ومحصلة اتخذها مفتتحا لكتابه الذي يبدأ وينتهي بالأسئلة. أسئلة عن الهوية والخلطة من المتناقضات بين الوافدة والمحلية، وكذلك عن مشاركة القارئ مع الكاتب، ووعي الشاعر بالقصيدة، وكيف يصبح الكاتب أسير نصه، وفكرة تخلصه من الإرث الشعري أو الهروب من قطيعة الأفكار.
كما يبحث الكتاب أيضا عن دلالات وجود لغة مشتركة بين الناس وصناع المسرح، وعلاقة المسرحي مع الكلمة.. وغيرها من المواضيع والأفكار التي يثيرها.
وقد استفزني كتاب “جسور” للغوص مع الكاتب عبدالسلام الفقهي في دهاليز وتفاصيل هذا العمل، الذي كنت شاهدة على بعض حواراته، والتطرق مع الكاتب للحديث عن محطاته التي استوقفته والممرات التي عبرها مع الكتّاب والمثقفين الليبيين.
الكاتب والقارئ
"جسور" يستنطق الكتاب وأفكارهم وهو بمثابة حلقة وصل بين الكاتب والقارئ، أو بين القارئ وهوامش الكتابة وظلها
الجسور والأسئلة ثم المحتوى، تسأل “العرب” عبدالسلام الفقهي كيف نفهم العنوان عبر هذه الثلاثية؟ ليجيبنا “محاولة للخروج من القوالب التقليدية للعناوين، ولا أدري إن كنت استطعت فعل ذلك أم لا، الخروج بهذا العنوان جاء بعد سلسلة من التصورات والملاحظات من زملاء مهنة وكتاب، إضافة إلى أرضية مهمة تقدمها مادة الكتاب في حواري مع الكاتب والأديب يوسف الشريف الذي تقوم فلسفته في أدب الطفل وكل ما كتب عن الثقافة بشكل عام على السؤال”.
ويضيف “الجسور هي حلقة وصل بين الكاتب والقارئ، أو بين القارئ وهوامش الكتابة وظلها، ربما قرأنا لكاتب ما رواية أو قصة وتكون لدينا انطباع ما عن العمل، هنا أقدم إن صح التعبير، الجزء المكمل للصورة عبر استنطاق الكاتب وأفكاره بالخصوص، وبالتالي يمكن للقارئ تتبع أثر تلك الأفكار ومرجعياتها ومقارنتها أيضا باستنتاجاته، وهذا يعطينا شكلا أكثر اتساعا لتمظهرات العمل، والاستنطاق لا يتوقف عند فنون السرد والشعر فقط بل يتعداه أيضا إلى النقد والمسرح والترجمة.. إلخ”.
ويذكر أنه في البحث عن العنوان الشارح لجسور، كان عليه مواجهة إشكالية الخروج من القالب (حوارات، لقاءات) وطرح سؤال: ما العامل المشترك بين المواد الحوارية في “جسور”؟ بالطبع الأسئلة في النهاية عامل مشترك رئيس بينها وهنا وجد الصيغة مقبولة إلى حد ما وانتهى العنوان كما هو موجود بالكتاب.
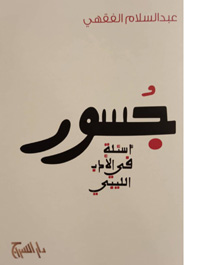
الحديث عن الأسئلة يجرنا إلى عالم الكاتب يوسف الشريف وسؤال الطفولة لديه، يقول الفقهي “حواري مع الكاتب يوسف الشريف أصفه بالسهل الممتنع، للوهلة الأولى تعتقد أن طرح السؤال تقابله إجابة أو استجابة مشجعة على الأقل، لكن الأمر تطلب الكثير من الوقت، لأن يوسف الشريف هو طفل في عمر الثمانين، طفل موسوعي يتنفس الكتب بمزاج وعناد وفضول يدفعك إلى التسلح بـ’وسعة بال’ مع وفرة لا بأس بها من الحظ”.
ويضيف “الحقيقة أن مشروع الحوار كاد أن ينهار في البداية، لأنني لم أكن متسلحا بما فيه الكفاية من الدراية للتعامل مع ‘سافو’ كما يحب أن ينادى، غير أن القدر وفر لي فرصة الحديث مع الشريف لمدة تقارب الثلاثة أسابيع مهدت للحوار وكونت مع الشيخ الطفل كيمياء أدخلتني إلى عالمه، عندها تحدث سافو”.
ويلفت إلى أن المعرفة عند يوسف الشريف تبدأ وتنتهي بالأسئلة لذلك تبنى هذا الخط في طرح أفكاره حول أدب الطفل، فكانت القصص في جوهرها مبنية على أدوات الاستفهام “كيف، لماذا” وقاده ذلك أيضا إلى تأليف المعجم الميسر، مستندا على فاعلية قيمة هامة ورئيسة وهي “الحرية” أي تخلص الطفل من إرث الارتباك ودفعه إلى النقاش وطرح أسئلته الخاصة والاشتباك معها.
ويواصل “إذا فالكاتب يوسف الشريف معجون بروح السؤال وهو ما دونه في كتابه الخلاصة، وقد وجدت في هذه الخلاصة أيضا الكثير من مفاتيح يوسف الشريف، وعلاقته بالأدب والكتابة، ما شكل مظلة داعمة للعنوان المكمل لجسور”.
إجابات الكاتب منصور بوشناف عن الهوية تضعنا في أوجه من وجوهها أمام حالة الكيان الأدبي وتحديدا حدود تماهي القارئ مع الكاتب، يعلق الفقهي على ذلك قائلا “إذا كنت تقصدين فهم القارئ لدلالات النص الأدبي خصوصا في ما يتعلق بمفهوم الهوية والكيان، فهذا يتوقف من وجهة نظري على وعي القارئ ووجهة نظره في تمثلات كياننا الليبي، وبوشناف حاول أن يوصف طبيعته الحالية بناء على خلفيات تاريخية وثقافية واجتماعية وسياسية، تلك الخلفيات كانت أشبه بحركات تكتونية، بالمفهوم الجيولوجي، حيث أدت إلى تشققات وصدوع وانزياح كتل وتقارب أخرى”.
الكاتب (روائي، قاص، شاعر، ناقد، مترجم) هو إنسان في النهاية، وعلى المحرر الأدبي إدراك ذلك
ويتابع “جغرافيا شاسعة وثروات دفينة، قلة سكانية وتنوع ثقافي، مستعمر أوروبي يطل برأسه بين زمن وآخر محموما بأحلام البقاء، حروب ونزوح ونزاع وصراع وهجرة والقائمة تطول، وبالتالي البحث عن مشرط يشرح هذا الواقع ويعريه أمر لازم، وكان السرد الليبي أحد هذه المشارط قد قدم نماذجه في روائع كثيرة لعدد من الكتاب، وتأتي ‘العلكة’ و’الكلب الذهبي’ لمنصور بوشناف ضمن تلك النماذج حيث تستعرضان جانبا من ارتدادات تلك الصدوع عبر فهم طبيعة ما حدث في عقد الثمانينات ثم الذهاب إلى ما قبلها لمعاينة الإرهاصات والمسببات. والقارئ وفق ما ذكرت هو جزء من هذه الحكاية فهو البطل والكاتب والضحية”.
تسأل “العرب” الفقهي كيف وجد معنى “وعي الشاعر بنصه” خصوصا إذا تحدثنا عن مجموع حالات إنسانية تدنوا من الاغتراب وتبتعد كما في نصوص الشاعرة سميرة البوزيدي؟ فيجيبنا “نثر أي شاعر هو رصد لحالة إنسانية، ونصوص الشاعرة سميرة البوزيدي جزء من هذا الرصد، وما يميز هذه النصوص شحنتها النقدية العالية والصريحة، تلتحف اللغة وتمارس باستمرار مهمة الهدم والبناء، هدم ما يمكن أن يصبح معتادا ومكررا وبناء خطاب ينتصر للذات التي تواجه هاجس التشوه ولكي لا تصبح زومبي”.
ويضيف “من وهج هذا الدفق النثري رصدت شواهد نصية مقاومة للحرب التي شهدتها طرابلس أكثر من مرة وكان آخرها 2019، كانت النصوص تنشرها الشاعرة على صفحتها بالفيسبوك مشبعة بغضب دون أن يصل إلى مرحلة العمى. هو غضب ينشد البصيرة الشعرية لدى من يبدو أن نفسه اغترابي، لكنه في العمق يلتصق بالتراب ويبحث عن صيغة واقعية للحياة دون ‘ميك آب’. وهنا التقطت من هذه القصائد بعض الأفكار والصور النفسية وكونت من خلالها جسرا من التساؤلات طرحتها على الشاعرة”.
الكتابة والصحافة

الكتاب يقتبس شيئا من روح الصحافة الأدبية في عناوينه التي تنحاز لقالب السلطة الرابعة بقوة، يعلق مؤلفه “القصدية من عدمها في وضع العناوين لن تمنحني إجابة مقنعة في جعلي إياها على هذه الصورة، لأن العنوان يتسرب من ظلال المفردات وينبثق كجزء أصيل من نسيجها، هكذا يبرز أمامك منفلتا في أحيان كثيرة من قيود الصياغة التحريرية ومن ضرورات النفس الأدبي. وفي النهاية قد تجد سلطة اللاوعي تدفعك لصالح الاتجاهين هنا أو هناك، فالصحافة القاعدة التي نهضت عليها خطواتي الأولى في فهم سياق ومنطق الكتابة، والأدب قادني إلى فضاءات الكتابة على اتساع جنونها وما زلت عموما تلميذا للمسارين”.
اقترب الفقهي من عوالم الشاعر أحمد بللو الذي تعرفنا عليه مسرحيا في “جسور”، يقول “الشعر والمسرح ينتميان إلى الكتابة، فكلاهما من رحم واحد، إلا أن المسرح حول الكتابة إلى حركة شخوص وأزياء وحوار وبكاء وفرح وكل تمثلات الحياة، أي إلى تجسيد حياتي للكتابة وهو الضوء الذي سحر خيال بللو وقاده إلى المسرح بعد أن وضع أسئلته أمام الشعر والصحافة ووجد أن قلق الأسئلة الذي يسكنه كان أكبر من كلاهما، وأن الاجابة تحتاج إلى مسرحة الكتابة لبيان أثرها بعد الانتقال من أثر السكون إلى أثر الحركة”.
ويتابع “أضيف أن تجربة بللو كانت جزءا من أسئلة المسرح في هذا الكتاب التي أجاب عنها كل من الكاتب المسرحي البوصيري عبدالله الذي خصص كامل حياته وفكره في التأليف للمسرح والكتابة عن تاريخه، وكذلك القاص والمسرحي عبدالعزيز الزني حيث شغف بعالم الخشبة وتفاصيله”.
الحديث عن “جسور” يعني التعامل مع أذواق وأمزجة مختلفة للكتاب، وهذا ما يؤكده الفقهي قائلا “نعم، بطبيعة الحال، وليس جسور استثناء، فكل كتاب له طابع حواري هو حمولة ضخمة من الأمزجة وتدريب للصحافي الأدبي في كيفية التحكم في أعصابه للحصول على مادته”.
ويختم حديثه لـ”العرب” معتبرا أن “الكاتب (روائي، قاص، شاعر، ناقد، مترجم) هو إنسان في النهاية، وعلى المحرر الأدبي إدراك ذلك وفهم أننا في بيئة مختلفة يغزوها قلق حياتي عام، وبالتالي يجب ألا أتفاءل كثيرا بالحصول على إجابة سريعة من الكاتب المستهدف، وبذلك يكون العنصر الحاسم هنا ‘الصبر’. بالتأكيد ليس صبر أيوب، لكنه الزمن الذي يمنح المحرر صرف النظر عن الحوار من عدمه”.






















